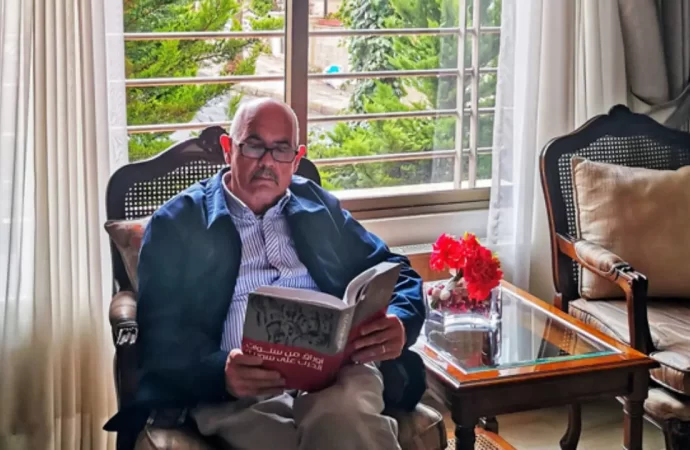في ذكرى “هبَّة نيسان”- من مقال قديم
كتب احمد جرادات
هوامش على متن “هبَّة نيسان”
شكَّلت ما درجَ الأردنيون على تسميتها بـ هبَّة/انتفاضة نيسان التي اندلعت في 17 نيسان/أبريل 1989 حدثاً كبيرًا وعلامة فارقة في تاريخ الأردن المعاصر منذ عام 1970؛ إذ أنها عمَّت مختلف أرجاء البلاد، من معان التي انطلقت منها جنوبًا إلى إربد شمالًا؛ وقدَّمت نحو خمسة عشر شهيدًا وعشرات المصابين ومئات المعتقلين، ناهيك عن “المختفين” والمطارَدين؛ ومثَّلت أول احتجاج شعبي على بدء مرحلة التحوُّل النيوليبرالي والتخلي عن الدولة الريعية؛ كما شكَّلت حدثًا غير مسبوق، وهذا هو الأكثر أهمية والأقوى دلالة، من حيث أنها كانت أول صِدام مباشر وعنيف ينشب بين نظام الحكم وقاعدته الاجتماعية من “الكتلة الشعبية الأردنية” منذ ما بعد أحداث أيلول عام 1970، الأمر الذي سيشكِّل الإرهاصات الأولى لتغيير وجه العلاقة بين نظام الحكم والأردنيين في وقت لاحق.
المُخرجات: عناوين كبرى ومضامين صغرى
تكرَّرت ما أسميها “تراجيديا الأوزار والثمار” التاريخية، إذ أن الجماهير المنتفضة التي صنعت الهبَّة والمناضلين الذين أيَّدوها وشاركوا فيها حمَلوا أوزارها، بينما قطفَ رجال السلطة والانتهازيون ثمارها. واستطاع النظام تحويل التحدي الكبير إلى فرصة ثمينة، وعملَ على إعادة إنتاج نفسه، وخرج إلى الشعب بعباءة مقصَّبة – أسماها التحول الديمقراطي- وتمكَّن من إعادة الجماهير المنتفضة-الناشز بنَظره- إلى بيت الطاعة.
أما مناضلو الأحزاب والقوى السياسية المعارضة في الحقبة العُرفية، بمن فيهم الشيوعيون، فقد تفاوتت ردود أفعالهم واستجاباتهم بعد مغادرتهم السجن والشارع وعودتهم إلى بيوتهم:
فمنهم مَن سارَ على خُطى امرئ القيس وتخلَّى عن الثأر لأبيه الملك القتيل مقابل الاحتفاظ بجلده:
“لقد طوَّفتُ في الآفاق حتى رضيتُ من الغنيمة بالإياب”؛
أو في حالٍ أحسن وضعَ اللوم على قومه وردَّد قول العرجي:
أضاعوني وأيَّ فتى أضاعوا ليوم كريهةٍ وسَداد ثَغرِ؛
منهم:
من مشى وراء الحلم الرومنسي القديم “من السجن إلى البرلمان”- كنتُ أحدهم-
لتحق بصفوف النظام وحظي بعضَّة من كعكته؛
ومنهم مَن آوى إلى جبل يعصمه من ماء الطوفان الملوَّث ولاذَ بصمت الاعتكاف بانتظار مكر التاريخ بدلًا من حتميته- صرتُ أحدهم؛ ومنهم من احتفظ
بالاسم والشكل وتخلَّى عن المضمون والمبدأ.
لقد حلَّتْ حقبة جديدة، بل عصر جديد، حاملًا معه “ثقافة” جديدة بدأت بتجريف الثقافة الوطنية التقدمية التي تدهورت وانحطَّت لتحلَّ محلها الثقافة النيو ليبرالية، بل “اللاثقافة”، وسادت أفكار العولمة الأوليغارشية و”فلسفة” بائسة ودِين جديد اعتنقتْه نُخب ثقافية وسياسية عديدة، رُكناه الأساسيان”نهاية التاريخ”، أي انتصار الرأسمالية المتوحشة النهائي، و”صدام الحضارات” بدلاً من كفاح الشعوب ضد الإمبريالية ومن أجل التحرر الوطني والتحرير والتنمية المستقلة. وطفقَ العديد من المثقفين يلهثون خلف الجوائز والمكافآت والانتشار في النوافذ الثقافية والإعلامية المُضاءة بالنفط والغاز، حيث “يحدِّد اللحنَ مَن يدفع للزمَّار”. ووصل الأمر ببعضهم في سنوات الحرب على سوريا إلى حد تأييد القوى الإرهابية الظلامية التابعة لمشغِّليها العالميين والإقليميين.
مأزق الشيوعيين الأردنيين
بالإضافة إلى أنَّ الأغلبية العظمى من المعتقلين في سجن “سواقة” الصحراوي كانت من الحراكيين المنتفضين في الجنوب، فقد شكَّل الشيوعيون أغلبية المعتقلين من أعضاء الأحزاب والتنظيمات السياسية، الذين كان من بينهم أيضًا أعضاء في الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب البعث و”مستقلون”. وكان الشيوعيون قبل فترة وجيزة من اعتقالهم قد أعلنوا وحدة هشَّة ومتوجِّسة بين أطراف الحركة الشيوعية الأردنية، ما لبثتْ أن تفككتْ بعد خروجهم، بل إن بوادر الوهن والتفكك ظهرت داخل السجن. وبدلاً من تحويل ذلك التحدي في السجن إلى فرصة، مثلما فعلَ النظام، وذلك بتعزيز الوحدة فيما بينهم وتَدارُس الأوضاع الناشئة واجتراح حلول جديدة للمشكلات الجديدة التي طرحها الحدَث والمرحلة، فقد تحوَّلت الفرصة المحتملة إلى مفوَّتة.
رحلة موسكو الفاصلة
بعد الخروج من السجن، وبعد إجراءات الإفراج عن جوازات السفر المحتجزة ورفع حظر السفر التي استمرت عقودًا إبان الأحكام العرفية، تلقَّى الحزب دعوة من قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي لزيارة موسكو للتعرُّف على مشروع ميخائيل غورباتشوف الغامض حينئذٍ (بيريسترويكا وغلاسنوست- أي إعادة البناء والشفافية أو المكاشفة) لِما زُعمَ أنه إصلاح وتجديد الاتحاد السوفييتي والاشتراكية، وعلمْنا هناك أنهم وجَّهوا دعوات مماثلة للأحزاب الشيوعية العالمية للغرض ذاته، طبعاً بهدف مُضمَر وهو إقناع الأحزاب الشيوعية بالمشروع وتأييده، أو لإثارة حالة من الارتباك في صفوف الحركة الشيوعية العالمية، تَحولُ دون اتفاقها على موقف موحد مناهض للمشروع وفضحه قُبيْل الانفجار العظيم القادم (الرأي الأخير بأثر رجعي).
أرسلَ الحزب وفدًا من المكتب السياسي واللجنة المركزية إلى موسكو، كنتُ محظوظاً بمشاركتي فيه. في موسكو عُقدت حلقات دراسية لمدة أسبوعين في أكاديمية العلوم الاجتماعية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، حاضرَ فيها عدد من أساتذة الأكاديمية من منظِّري مشروع غورباتشوف، وطرحوا أفكارًا غائمة وردَّدوا بعض “الآيات والأحاديث الماركسية” المبتورة من سياقاتها، واستشهدوا بشذرات معزولة من ماركس ولينين وغيرهما، ووزَّعوا كتاب غورباتشوف المتهافت “البيريسترويكا: تفكير جديد لبلادنا والعالم” (حقاً!) وكتيبات أخرى قليلة، أبرزها “وصية لينين السياسية”، وهي مجموعة رسائل ومقالات زُعم أن لينين كتبها وهو على فراش المرض العُضال الذي انتهى برحيله وأُطلق عليها اسم “وصية لينين”، والتي قال باحثون روس مرموقون فيما بعد إنها رسائل مزوَّرة، استخدمها كل من زينوفييف وتروتسكي ضد ستالين بهدف استبعاده من قيادة الحزب، وكذلك فعل خروتشيف بعد وفاته، ثم استخدمها غورباتشوف في “البيروسترويكا” لتحطيم الاتحاد السوفييتي والقضاء على الاشتراكية باسم لينين.
أكاديمية العلوم الاجتماعية
بعد تلك اللقاءات في الأكاديمية والجولات “الحرة” التي قمتُ بها بصحبة ومساعدة بعض طلابنا في أماكن مختلفة من العاصمة موسكو، ومن أبرزها شارع الفن “أرابات”، الذي أقام فيه شاعر روسيا العظيم بوشكين لفترة من الزمن (قيل إن أصل الاسم عربي وهو “الرباط” لأن أجدادنا العرب المسلمين أيَّدهم الله بنصر من لَدُنه ووصلوا إلى ذلك المكان واتَّخذوه رباط خيلهم، فسُمي بهذا الاسم). ويبدو أن غورباتشوف أراد لهذا الشارع أن يلعب دوراً شبيهاً بدور “هايد بارك” في لندن من حيث حرية الرأي والتعبير، لكن باتجاه واحد منظَّم، وهو معاداة الشيوعية، حيث شهدتُ بنفسي الهجوم الحاد والسخرية البذيئة والعداء الصريح للاتحاد السوفييتي وثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى والحزب الشيوعي السوفييتي والزعماء الشيوعيين السوفييت واحدًا واحدًا، من لينين إلى تشيرننكو وحتى غورباتشوف نفسه، وللاشتراكية والماركسية ومنظِّريها الأوائل، بمن فيهم، بل على رأسهم، ماركس وإنجلز غير الروس، الذين صوَّروهم على شكل الدمية الروسية الشهيرة “متروشكا” وبناتها الشبيهات بها، بدءأً بماركس وانتهاء بأصغرهن غورباتشوف الذي لم يسلم رأسه من الهجوم، طبعًا لأنه كان يجب أن ينتهي بانتهاء دوره. شهدتُ تشنيعات أشكالًا ألوانًا، بالرسم والخُطب والغرافيتي والموسيقى والغناء والمنشورات واللافتات، لوَّثت الهواء الذي تنفَّسته قصائد أعظم شعراء القومية الروسية بوشكين، التي وصفها النقاد أجمل وصف بأنها “موسيقى في أشعار وتماثيل في صور شعرية”. لقد كان مشهد “أرابات” بمثابة بروفة “ربيع مسكوبي” مبكر في البلدان الاشتراكية.
أثناء فترة الزيارة لاحظتُ أن من “أضخم” الأحداث الشعبية التي دُقَّت لها الطبول كان افتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة في موسكو في عهد غورباتشوف “الإصلاحي”. طلبتُ من أحد طلابنا اصطحابي إلى هناك، فقادني إلى ساحة بوشكنسكايا بموسكو، مسرح الحدث. كان المشهد لا يصدَّق: آلاف مؤلفة من الناس يصطفُّون في طوابير “دودية” لم أستطع رؤية أولها، قيل لي إن العدد يصل إلى خمسة آلاف شخص يومياً يتدفقون من مدن أخرى إلى العاصمة للحج إلى ماكدونالدز. أردتُ أن أتحدث إلى أحدهم، فذهبنا إلى آخر الطابور وأخذنا موقعنا فيه. كان أمامنا شاب وصديقته، سألتهما عن سبب وجودهما هناك، فأجابت الفتاة بنبرة لا تخلو من استخفاف بسؤالي:
ألا ترى؟ نريد أن نشتري ماك، “بغ ماك” Big Mac (الكلمة الأخيرة قالتها بالإنجليزية).
– ولكنكما ستقفان لساعات طويلة قبل أن تصلا إلى الشباك؟
فردَّ الشاب بأنهما مستعدان للانتظار حتى صباح اليوم التالي إذا اقتضى الأمر.
– وهل يستحق ساندويش “ماك” كل هذا العناء؟
– طبعاً طبعا، كرَّرها.
– مع أن الغرب نفسه يصنفه بأنه “جَنك فوود”؟
– لا نصدِق، هذه دعاية شيوعية!!.
دعاية شيوعية؟ أإلى هذا الحد انحدر الأمر؟ قلت لمرافقي.
عُدنا إلى أكاديمية العلوم الاجتماعية، وبناءً على إلحاحي مررْنا بمكتب الحجوزات التابع للأكاديمية كي نشتري تذاكر دخول إلى مسرح البولشوي العظيم الذي طالما حلمتُ به، والذي تحقَّق فعلاً. خلفَ “الكاونتر” لفتَ اهتمامي حديث بدا غاضب اللهجة بين موظفتين، بينما كانت إحداهما تبيعنا التذاكر. بعد خروجنا من المكتب، سألتُ رفيقي عن فحوى الحديث، فقال إنهما تحتجان على سهولة توفير تذاكر الدرجة الأولى للأجانب من قبل الحزب الشيوعي، بينما المواطن السوفييتي العادي لا يستطيع الحصول على تذكرة من أية درجة بعد شُهور.
إذن “المسألة” تتعدى كونها رغبة في تذوُّق وجبة “بغ ماك مع فرينتش فرايز ولارج كوك” جديدة عليهم، أو في شراء تذكرة لمسرح البولشوي، بل ثمة وراء الأكمة شُغل دؤوب.
بعد الأكاديمية والشارع باتَ واضحًا لي تمامًا أن “مشروع” إصلاح وتجديد الاتحاد السوفييتي والنظام الاشتراكي ما هو إلا مشروع تفكيك الاتحاد السوفييتي والقضاء التام على النظام الاشتراكي. وعلينا أن نفكر ونحلل ونعدَّ الخطط لمواجهة هذا الاحتمال وأن نتخذ موقفًا مناهضًا له بوعي. وأود هنا أن أؤكد أن رأيي هذا ليس حكمة بأثر رجعي، وإنما كوَّنتُه وقُلتُه لعدد من الرفاق أعضاء الوفد هناك وعُدتُ به إلى اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي عُقد خصيصًا للاطلاع على حصيلة زيارة الوفد الحزبي وتقييم استخلاصاته، حيث قامت القيامة، إذ دافع بعض الرفاق عن مشروع غورباتشوف باعتباره مشروعًا إصلاحيًا حقيقيًا، ورأوا أن ما قلتُه يجب ألا يُعمَّم على أعضاء الحزب، لأنه سيؤدي إلى إشاعة الإحباط واليأس في نفوسهم وبين صفوفهم.
لا ريب في أن انهيار الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية الأخرى وتحوُّلَها إلى الرأسمالية بعكس اتجاه التاريخ، أو ربما باتجاهه “حرفيًا”، أي عند نقطة النكوص في حركته اللولبية، كان له أثرُ “الصدمة والرعب” علينا، كما هو على الحركة الشيوعية وحركة التحر العربي والعالمي بأسرها. ففي سنوات الكفاح المجيد، كان إيماننا بقضيتنا لا يتزعزع، فلم نكن نخاف من القمع ولا نخشى اقتحام الصعاب ولا نتوانى عن التضحية في سبيل “القضية”، حتى تحوَّلنا من مناضلين إلى مضحِّين- وشتان بينهما- ولسان حالنا يلهج بالدعاء المنسوب إلى عمر بن الخطاب: “اللهم إنا لا نسألك حملًا خفيفًا بل ظهرًا قويًا”. آنئذٍ كان الاتحاد السوفييتي ظهرَنا وجدارنا الاستنادي المعنوي، وبانهياره كُسر ظهرنا. فشعرَ كثيرون بالإحباط واليأس، و”كَفروا” بالاشتراكية والماركسية، وحتى بالتحرر الوطني، واعتنقوا دينًا جديدا،ً هو دين الليبرالية المعولم الذي يَجُبُّ كل ما قَبْله ولا نبيَّ بعده.
باليه “روميو وجولييت ” على مسرح البولشوي
لعلَّ ما ساعدَني على تخفيف هول الصدمة والشعور بالهمِّ والغمِّ الذي أصابني في رحلة موسكو أنني حققتُ حلمًا شخصيًا قديمًا، وهو زيارة مسرح البولشوي العظيم ومشاهدة فرقة الباليه الأولى على خشبته. وها هو الحلم يتحقق: الولد ابن قرية بشرى في سهل حوران بشمال الأردن الذي درسَ حتى صف “التوجيهي” على نور السراج نمرة أربعة وكتبَ وظيفة النسخ عشر مرات في كل مرة على الطبلية جاثمًا على ركبتيه وذهبَ إلى مدارس مدينة إربد سيرًا على قدميه في الوحل بجزمة الكاوشوك “باتا” ذات الرائحة الكريهة، والرجل الذي قضى سنوات شبابه مرتحلًا بين الزنازن والسجون أو مُلاحَقًا ومتواريًا عن الأنظار أو محرومًا من العمل والسفر في سجن كبير يُدعى الوطن، والقادم للتو من سجن دشَّنته هبَّة نيسان وحرَّرته منه، يدخل مسرح البولشوي القيصري العظيم، يمشي الهوينى كي لا يعكِّر صفو الجَلال وسحر الموسيقى، مرتديًا “بدلة” وربطة عنق كما تقتضي “دكتاتورية” تقاليد المكان المعشوقة! لا أنسى تلك النشوة والهيام والشعور بانعدام الجاذبية الأرضية وأنا أتأمَّل جمال المسرح الأخاذ من الداخل، أُبَّهتَه وعبقَ تاريخه، أسقفَه وجدرانَه وطبقاتِه وشرفاتِه ولوحاتِه ونقوشَه وأرضيتَه ومقاعدَه، وأنا أُشاهد باليه مسرحية شكسبير الشهيرة “روميو وجولييت” بأداء فرقة باليه البولشوي الأولى الأروع في الدنيا.